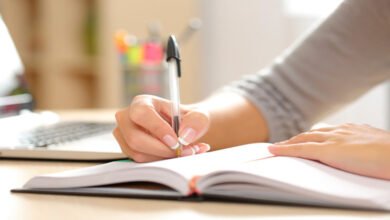سحر البيان (كناية)

سحر البيان (كناية)
—————–
الكناية: الحجاب الرقيق بين اللفظ والمعنى.
إنَّ للغةِ العربيةِ سَرايا من الجمالِ تكمُنُ خلفَ كلِّ حرفٍ وكلمة، وإنَّ البيانَ فيها لَكالمَحارِ الذي يَخفي في جوفهِ لؤلؤةَ المعنى. ومن أبهى هذه السرايا وأجملها الكناية؛ سِتارٌ من رقيقِ اللفظِ يواري خلفَهُ حقيقةً أبهى، ومعنًى أصفى. ليست الكنايةُ محضَ خيالٍ محلِّق، بل هي تجسيدٌ فنيٌّ للحقيقةِ عبرَ الإشارةِ والإيماء.
إنَّ الكنايةَ في جوهرها عُدولٌ عن اللفظِ الصريحِ إلى لازمِ معناهُ المشهور؛ فالمتكلّمُ يريدُ المعنى، لكنهُ يأبى أن يُخرِجَهُ عَريانًا للناظر، فيُلبسهُ ثوبَ اللفظِ الذي يُلازمهُ ويتبعهُ حيثُ سار.
هي لفظٌ أُريدَ بهِ لازمُ معناهُ مع جوازِ إرادةِ المعنى الأصلي. أي أن تقولَ شيئًا وتقصدَ ما يلزمُ عنهُ حتمًا. فلو قلتَ: “فلانٌ كثيرُ الرمادِ”، فإنَّ المعنى الأصليَّ هو كثرةُ الرمادِ حولَ بيته، لكنَّ المقصودَ هو الكرمُ والجودُ، إذْ كثرةُ الرمادِ تنشأُ عن كثرةِ إيقادِ النارِ للطبخِ وإطعامِ الضيفان. فالمعنى الحقيقيُّ لا يُنفى، بل يُتَّخذُ جسرًا نعبرُ منه إلى المعنى البلاغيِّ الأبهى.
جمالُ الكنايةِ يتجلّى في أنَّها تُخفي المعنى لتُظهرهُ أبهى وأجلى؛ فهي تُحرّكُ الذهنَ وتستفزُّ الفكرَ في المتلقّي ليصلَ إلى المقصودِ بنفسِه بعد رحلةٍ قصيرةٍ من التفكيرِ اللذيذ. وهذه الرحلةُ تُكسبُ المعنى قوةَ اليقينِ وجلالَ البرهان.
الكنايةُ تُهذّبُ القولَ وتُجمّلُ المعنى؛ فبدلًا من التصريحِ الذي قد يجرحُ الذوقَ أو يُفقدُ الأثرَ، تُستخدمُ الإشارةُ الرقيقةُ التي تُلامسُ المعنى دون أن تَصرُحَ به.
وترتقي الكنايةُ بالمعاني المجرّدةِ لتلبسها ثوبَ الحسّ الملموس. فبدلًا من أن تقول: “هذا الرجلُ غبيٌّ”، تقول: “ما يَنفكُّ يحملُ عقلَهُ في راحةِ يديه”؛ فتجعلُ الغباءَ صورةً محسوسةً لا صفةً جامدة.
وهي أيضًا أداةُ مبالغةٍ رشيقةٍ لا تجرحُ الصدق، لأنها تُقدّمُ الدليلَ المحسوسَ على الصفة. كقولهم في النومِ الطويل: “فلانٌ يحملُ عصاهُ معهُ في فراشهِ”؛ كنايةً عن طولِ نومه حتى كأنه لم يُفارق عصاهُ حين اضطجع.
الكنايةُ هي أمُّ الرمزِ في البيانِ العربي؛ فهي التي تُعلّمُ القارئَ أنَّ الكلمةَ الواحدةَ قد تحملُ عوالمَ من الدلالاتِ تتجاوزُ معناها القاموسيَّ المباشر.
إنها تُحوّلُ الصفةَ إلى كيانٍ مستقلٍّ يتّخذُ مظهرًا حسيًّا؛ فـ”طولُ الباع” رمزٌ للمهارةِ والقدرة، و”بياضُ الوجه” رمزٌ للشرفِ والنقاء. إنها تجعلُ الرابطَ بين الدليلِ والمدلولِ رابطًا ثقافيًّا راسخًا في وجدانِ الأمة، حتى يَكادَ اللفظُ ينصرفُ إلى معناهُ البلاغيِّ مباشرة.
وقد زخرت النصوصُ القرآنيةُ والحديثُ النبويُّ والشعرُ العربيُّ قديمُهُ وحديثُهُ بروائع الكناية وبديعها.
قال تعالى في سورة الكهف: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾.
الكناية: كنايةٌ عن العيبِ الذي أحدثه الخضرُ في السفينة، ليحميها من ظلمِ الملك الذي يأخذُ السفنَ الصالحةَ غصبًا.
وقال تعالى: ﴿أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾.
الكناية هنا عن المرأةِ التي تنشأُ في اللينِ والزينةِ والنعومةِ والرقة، فيُصوّرها التعبيرُ القرآنيُّ في أبهى صورةٍ من الأنوثةِ والرقةِ في الطبعِ والمظهر.
وقال ﷺ في وصفِ الصلاة: “أَرِحْنَا بها يا بلال”.
الكناية: كنايةٌ عن جعلِ الصلاةِ راحةً للنفوسِ وسكنًا للروح، لا مجردَ تكليفٍ وأداء، وهي كنايةٌ عن شغفِ النبيِّ ﷺ بها وحبِّه لها.
ومن الشعر العربي القديم قولُ الشاعرِ في وصفِ امرأةٍ ناعمة:
“تَمْشِي الهُوَيْنَا كَمَا يَمْشِي الوِجِي
كفراًغَةِ الرملِ لَمْ يَخْلُقْ لَهَا قَدَمُ”
الكناية: “كفراغةِ الرملِ” كنايةٌ عن ضَمرِ بطنِها ولطافةِ خصرِها. و”لم يخلق لها قدمُ” كنايةٌ عن خفّةِ مشيِها ورقةِ قدميها كأنها لا تحملُ ثقلًا.
وقولُ الخنساءِ في رثاءِ أخيها صخر:
“طويلُ النِّجادِ، رفيعُ العِمادِ، كثيرُ الرَّمادِ إذا ما شَتَا”
الكنايات: “طويلُ النجادِ” (موضعُ السيفِ على الكتف) كنايةٌ عن طولِ القامة، و”رفيعُ العمادِ” كنايةٌ عن الشرفِ والمكانةِ الرفيعة، و”كثيرُ الرمادِ” كنايةٌ عن الجودِ والكرم.
وفي الشعر العربي الحديث لم يتخلَّ الشعرُ عن هذا السحرِ البيانيّ، بل زادَهُ عُمقًا ورمزيةً، فالشعراءُ المعاصرون يستخدمونَ الكنايةَ لخلقِ دلالاتٍ نفسيةٍ واجتماعيةٍ مركّبة، كقولِ أحدهم في وصفِ الظلمِ السياسيّ:
“تلكَ الأيادي التي تَطولُ لتَسرقَ ضوءَ الشمسِ من العيون”.
الكناية: “تلك الأيادي التي تطول” كنايةٌ عن النفوذِ الطاغي والبطشِ المتجاوزِ للحدود.
إنَّ الكنايةَ، يا صاحبي، هي لُبُّ البلاغةِ وسِرُّ الفتنةِ في القول؛ هي التي تجعلُ اللفظَ حافلًا بالمعاني، وتُشركُ المتلقي في بناءِ الصورةِ واكتشافِ الدلالة. فليست اللغةُ مجموعةَ ألفاظٍ صمّاء، بل هي أرواحٌ تسري في المعاني، والكنايةُ هي أجنحةُ هذه الأرواحِ التي تُحلّقُ بنا في سماءِ الفكرةِ الأجمل. فمن أتقنَ الإيماءَ فقد أتقنَ البيان، ومن صرفَ الناسَ عن الحقيقةِ المباشرةِ إلى لازمِها البهيّ، فقد أُوتيَ من سحرِ البلاغةِ نصيبًا وافرًا.
بقلم الكاتبة : صباح أحمد العمري.