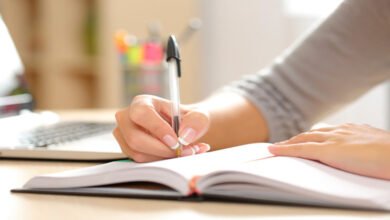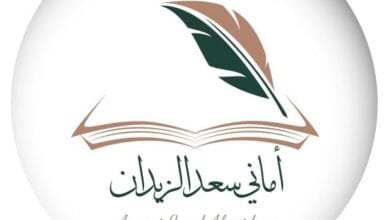الاحترافية في المشهد المسرحي السعودي

الاحترافية في المشهد المسرحي السعودي
المسرح في السعودية لم يعد مجرد نشاط ثقافي جانبي كما كان يُنظر إليه في بداياته، بل أصبح اليوم صناعة متكاملة تحمل ملامح الاحترافية، وتخوض رهانات المستقبل بوصفها أحد أعمدة المشهد الثقافي الوطني. وإذا ما نظرنا إلى تاريخ هذه التجربة نجد أنها مرت بمراحل متعاقبة؛ ففي السبعينيات والثمانينيات ظهرت فرق مسرحية محلية مثل فرقة جمعية الثقافة والفنون بجدة وفرقة الدمام المسرحية، حاولت أن تقدم عروضًا متكاملة تتجاوز الارتجال الفردي وتبحث عن صيغة تجمع النص والإخراج والأداء والديكور والإضاءة في وحدة واحدة، وهو ما يمكن أن نطلق عليه “البنيوية المسرحية”، أي تكامل العناصر الفنية والإدارية التي تمنح المسرح صفة الصناعة، وتجعل من العرض حدثًا مركبًا لا يقوم على ممثل أو نص بمفرده، بل على منظومة تتشابك فيها الرؤية الدرامية بالبعد التقني بالخطاب الثقافي. هذه البدايات أسست لوعي جديد بأهمية المسرح ليس كوسيلة للتسلية فحسب، بل كأداة ثقافية وجمالية قادرة على التعبير عن هموم المجتمع وتطلعاته. ومع مرور الوقت أخذت هذه البنية في التشكل عبر منصات متعددة، فمهرجان الجنادرية منذ الثمانينيات لم يكن مجرد تظاهرة تراثية، بل فضاءً لعرض نصوص تستلهم التاريخ وتعيد تقديمه في قوالب فنية معاصرة، بينما أتاح مهرجان المسرح السعودي الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون فرصة أكبر للتنافس بين الفرق، ولإبراز مواهب شابة مثل عبدالعزيز السماعيل الذي قدم أعمالًا مثل مسرحية “الظل” بوصفها نموذجًا على استلهام البيئة المحلية برؤية حداثية. وفي التسعينيات وما بعدها توسع المشهد ببطء لكنه احتفظ بملامح الجدية، حتى جاءت رؤية المملكة 2030 لتشكل نقطة انعطاف مفصلية، حيث تحوّل المسرح إلى جزء من استراتيجية وطنية واضحة، تسعى إلى تحويل الفنون من أنشطة جانبية إلى صناعات ثقافية مستدامة. وهنا ظهر الدور الكبير لوزارة الثقافة وهيئة المسرح والفنون الأدائية التي أسست برامج تدريبية داخلية وخارجية، وأطلقت مبادرات للإيفاد إلى معاهد عالمية لتأهيل الممثلين والمخرجين والتقنيين، كما دعمت تجهيز المسارح في الرياض وجدة والدمام بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من أنظمة إضاءة وصوت وديكور. هذا التطوير البنيوي انعكس بشكل مباشر على طبيعة العروض المقدمة، فمع مواسم كبرى مثل موسم الرياض وموسم جدة شاهد الجمهور عروضًا ضخمة تجمع بين الطابع الجماهيري والإنتاج الاحترافي، منها مسرحيات كوميدية حضرها نجوم عرب وخليجيون، وأخرى سعودية حاولت أن توازن بين الجاذبية التجارية والرصانة الفنية، الأمر الذي خلق جمهورًا واسعًا يعيد الاعتبار للمسرح كفضاء للتفاعل الجمعي. لكن هذه الطفرة تثير في المقابل أسئلة نقدية لا يمكن تجاوزها: هل استطاع المسرح السعودي أن يبني هوية مسرحية أصيلة تستمد جذورها من بيئته وتاريخه، أم أنه ما يزال يتأرجح بين استلهام القوالب العربية، خاصة المصرية، وبين تقليد النماذج الغربية؟ الإجابة ليست سهلة، فهناك محاولات جادة لبناء خطاب مسرحي سعودي خالص كما في أعمال جمعية الثقافة والفنون بالدمام، التي استلهمت تفاصيل الحياة اليومية المحلية، أو أعمال السماعيل التي قدمت الرمزي والواقعي بلغة سعودية واضحة، لكن في المقابل نجد عروضًا تجارية قدمت في المواسم الكبرى تفتقد العمق الفني وتعتمد على الضحك السريع، مما يعكس التحدي بين “المسرح بوصفه صناعة ترفيهية” و”المسرح بوصفه مشروعًا ثقافيًا”. هذا التحدي يتضاعف بسبب غياب النقد المسرحي المؤسسي، إذ لا توجد حركة نقدية منتظمة قادرة على مواكبة التجربة وتوثيقها وتحليلها بصرامة علمية، ولا أرشفة ممنهجة تحفظ ذاكرة المسرح السعودي وتتيح للأجيال الجديدة التعلم منها، وهو ما يجعل المنجز عرضة للنسيان أو التكرار. لذلك تبدو الحاجة ماسة إلى تأسيس معاهد أكاديمية متخصصة في الفنون المسرحية داخل الجامعات السعودية، وإلى تفعيل الصحافة الثقافية بوصفها أداة للنقد والتحليل، حتى لا يبقى المسرح محصورًا في النجاحات الفردية أو المواسم المؤقتة. إن المسرح السعودي اليوم يمثل مختبرًا للهوية الوطنية، ومنبرًا للتعليم والتوعية، وأداة لتشكيل الوعي الجمعي، وهو بهذا المعنى ليس مجرد خشبة وعرض، بل فضاء لإنتاج المعنى وصياغة الحاضر، وجسر للتواصل مع العالم من موقع الثقة بالذات. وإذا كان ما تحقق حتى الآن يعكس نجاحًا واضحًا في بناء البنية التحتية وتوسيع قاعدة الجمهور، فإن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تعميق البنية الفكرية والنقدية، وعلى تثبيت هوية سعودية أصيلة قادرة على الحوار مع التجارب العالمية دون أن تذوب فيها. وعندها فقط يمكن القول إن المسرح الاحترافي في السعودية لم يعد مجرد طموح أو تجربة ناشئة، بل أصبح صناعة ثقافية متكاملة، ومؤشرًا حضاريًا على نضج المشروع الوطني ضمن رؤية 2030، وواجهة فنية قادرة على المنافسة في المشهد العربي والدولي.